بسم الله الرحمن الرحيم
لا لقاء بين الإسلام والجاهلية
لا لقاء بين الإسلام والجاهلية
فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - (4 / 1898)
«قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ ، وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ ، فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ، ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها ، إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ ، وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً ، إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ» ..
إنها انتفاضة التبرؤ من القوم - وقد كان منهم وكان أخاهم - وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اتخذوا غير طريق اللّه طريقا. وانتفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيان على وشيجة وقد أنبتت بينهما وشيجة العقيدة.
وهو يشهد اللّه ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم. ويشهدهم هم أنفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم! وذلك كله مع عزة الإيمان واستعلائه. ومع ثقة الإيمان واطمئنانه! وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوما غلاظا شدادا حمقى. يبلغ بهم الجهل أن يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيهذي ويروا في الدعوة إلى اللّه الواحد هذيانا من أثر المس! يدهش لرجل يواجه هؤلاء القوم الواثقين بآلهتهم المفتراة هذه الثقة ، فيسفه عقيدتهم ويقرعهم عليها ويؤنبهم ثم يهيج ضراوتهم بالتحدي. لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم ، ولا يدعهم يتريثون فيفثأ غضبهم.
إن الإنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد. ولكن الدهشة تزول عند ما يتدبر العوامل والأسباب ..
إنه الإيمان. والثقة. والاطمئنان .. الإيمان باللّه ، والثقة بوعده ، والاطمئنان إلى نصره .. الإيمان الذي يخالط القلب فإذا وعد اللّه بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة. لأنها ملء يديه ، وملء قلبه الذي بين جنبيه ، وليست وعدا للمستقبل في ضمير الغيب ، إنما هي حاضر واقع تتملاه العين والقلب.
«قال : إني أشهد اللّه واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه».
اني أشهد اللّه على براءتي مما تشركون من دونه. واشهدوا أنتم شهادة تبرئني وتكون حجة عليكم : أنني عالنتكم بالبراءة مما تشركون من دون اللّه. ثم تجمعوا أنتم وهذه الآلهة التي تزعمون أن أحدها مسني بسوء.
تجمعوا أنتم وهي - جميعا - ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل ، فما أباليكم جميعا ، ولا أخشاكم شيئا :
«إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ» ..
ومهما أنكرتم وكذبتم. فهذه الحقيقة قائمة. حقيقة ربوبية اللّه لي ولكم. فاللّه الواحد هو ربي وربكم ، لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة ..
«ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها» ..
وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية كل دابة على هذه الأرض ، بما فيها الدواب من الناس. والناصية أعلى الجبهة. فهو القهر والغلبة والهيمنة ، في صورة حسية تناسب الموقف ، وتناسب غلظة القوم وشدتهم ، وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم ، وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم .. وإلى جانبها تقرير استقامة السنة الإلهية في اتجاهها الذي لا يحيد : «إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» ..
فهي القوة والاستقامة والتصميم.
وفي هذه الكلمات القوية الحاسمة ندرك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك التحدي .. إنها ترسم صورة الحقيقة التي يجدها نبي اللّه هود - عليه السلام - في نفسه من ربه .. إنه يجد هذه الحقيقة واضحة .. إن ربه ورب الخلائق قوي قاهر : «ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها» .. وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهرا. فما خوفه من هذه الدواب وما احتفاله بها وهي لا تسلط عليه - إن سلطت - إلا بإذن ربه؟ وما بقاء فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه؟ إن هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه ، لا تدع في قلبه مجالا للشك في عاقبة أمره ولا مجالا للتردد عن المضي في طريقه.
إنها حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا.
وعند هذا الحد من التحدي بقوة اللّه ، وإبراز هذه القوة في صورتها القاهرة الحاسمة ، يأخذ هود في الإنذار والوعيد :
«فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ» ..
فأديت واجبي للّه ، ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة اللّه سبحانه :«وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ»
يليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهلاككم ببغيكم وظلمكم وانحرافكم.
«وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً» ..
فما لكم به من قوة ، وذهابكم لا يترك في كونه فراغا ولا نقصا ..
«إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ» ..
يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع ، ويقوم عليكم فلا تفلتون ولا تعجزونه هربا! وكانت هي الكلمة الفاصلة. وانتهى الجدل والكلام. ليحق الوعيد والإنذار :«وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ».
لما جاء أمرنا بتحقيق الوعيد ، وإهلاك قوم هود ، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة مباشرة منا ، خلصتهم من العذاب العام النازل بالقوم ، واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء. وكانت نجاتهم من عذاب غليظ حل بالمكذبين. ووصف العذاب بأنه غليظ بهذا التصوير المجسم ، يتناسق مع الجو ، ومع القوم الغلاظ العتاة.
والآن وقد هلكت عاد. يشار إلى مصرعها إشارة البعد ، ويسجل عليها ما اقترفت من ذنب ، وتشيع باللعنة والطرد ، في تقرير وتكرار وتوكيد :
«وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ. أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ. أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ» ..
«وَتِلْكَ عادٌ» .. بهذا البعد. وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياق ، وكان مصرعهم معروضا على الأنظار ..
ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار ..
«وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ» ..
وهم عصوا رسولا واحدا. ولكن أليست هي رسالة واحدة جاء بها الرسل جميعا؟ فمن لم يسلم لرسول بها فقد عصى الرسل جميعا. ولا ننسى أن هذا الجمع في الآيات وفي الرسل مقصود من ناحية أسلوبية أخرى لتضخيم جريمتهم وإبراز شناعتها. فهم جحدوا آيات ، وهم عصوا رسلا. فما أضخم الذنب وما أشنع الجريمة! «وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ» ..
أمر كل متسلط عليهم ، معاند لا يسلم بحق ، وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان المتسلطين ، ويفكروا بأنفسهم لأنفسهم. ولا يكونوا ذيولا فيهدروا آدميتهم.
وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية اللّه وحده لهم والدينونة للّه وحده من دون العباد ..
كانت هي قضية الحاكمية والاتباع .. كانت هي قضية : من الرب الذي يدينون له ويتبعون أمره؟ يتجلى هذا في قول اللّه تعالى : «وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ» ..
فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين! والإسلام هو طاعة امر الرسل - لأنه أمر اللّه - ومعصية أمر الجبارين. وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر والإيمان .. في كل رسالة وعلى يد كل رسول.
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير اللّه والتمردعلى سلطان الأرباب الطغاة وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية ، واتباع الجبارين المتكبرين جريمة شرك وكفر يستحق عليها الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة .. لقد خلق اللّه الناس ليكونوا أحرارا لا يدينون بالعبودية لأحد من خلقه ، ولا ينزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم. فهذا مناط تكريمهم.
فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند اللّه ولا نجاة. وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعي الكرامة ، وتدعي الإنسانية ، وهي تدين لغير اللّه من عباده. والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وحاكميتهم ليسوا بمعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين. فهم كثرة والمتجبرون قلة. ولو أرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والمال.
لقد هلكت عاد لأنهم اتبعوا أمر كل جبار عنيد .. هلكوا مشيعين باللعنة في الدنيا وفي الآخرة : «وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ» ..
ثم لا يتركهم قبل أن يسجل عليهم حالهم وسبب ما أصابهم في إعلان عام وتنبيه عال : «أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ» ..
ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد : «أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ» ..
بهذا التحديد والإيضاح والتوكيد. كأنما يحدد عنوانهم للعنة المرسلة عليهم حتى تقصدهم قصدا :
.. «أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ»!!!
=================

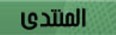

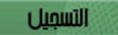
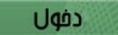

 المزاج
المزاج






