بسم الله الرحمن الرحيم
طبيعة الهدى وطبيعة الإيمان
طبيعة الهدى وطبيعة الإيمان
فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - (3 / 1199)
« أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124) فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) [الأنعام : 122 - 125] ».
إن هذه الآيات في تصوير طبيعة الهدى وطبيعة الإيمان إنما تعبر تعبيرا حقيقيا واقعيا عن حقيقة واقعية كذلك.
إن ما يبدو فيها من تشبيه ومجاز إنما هو لتجسيم هذه الحقيقة في الصورة الموحية المؤثرة ولكن العبارة في ذاتها حقيقية.
إن نوع الحقيقة التي تعبر هذه الآيات عنها هو الذي يقتضي هذه الإيقاعات التصويرية. فهي حقيقة ، نعم.
ولكنها حقيقة روحية وفكرية. حقيقة تذاق بالتجربة. ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجربة ولكن لمن ذاقها فعلا! إن هذه العقيدة تنشئ في القلب حياة بعد الموت وتطلق فيه نورا بعد الظلمات. حياة يعيد بها تذوق كل شي ء ، وتصور كل شي ء ، وتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة. ونورا يبدو كل شيء تحت أشعته وفي مجاله جديدا كما لم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوّره الإيمان.
هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ. يعرفها فقط من ذاقها .. والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه التجربة. لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها.
إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية ، التي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب. فهو موت ..
وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله .. فهو موت .. وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية .. فهو موت ..
والإيمان اتصال ، واستمداد ، واستجابة .. فهو حياة ..
إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع .. فهو ظلمة .. وختم على الجوارح والمشاعر .. فهو ظلمة ..
وتيه في التيه وضلال .. فهو ظلمة ..
وإن الإيمان تفتح ورؤية ، وإدراك واستقامة .. فهو نور بكل مقومات النور ..
إن الكفر انكماش وتحجر .. فهو ضيق .. وشرود عن الطريق الفطري الميسر .. فهو عسر .. وحرمان من الاطمئنان إلى الكنف الآمن .. فهو قلق ..
وإن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود ..
وما الكافر؟ إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور .. إن هو إلا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود ، فهو منقطع الصلة بالوجود. لا تربطه به إلا روابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود. في أضيق الحدود. في الحدود التي تعيش فيها البهيمة. حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود! إن الصلة باللّه ، والصلة في اللّه ، لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد الخالد. ثم تصله بالكون الحادث والحياة الظاهرة .. ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان. الموصولة على مدار الزمان .. فهو في ثراء من الوشائج ، وفي ثراء من الروابط. وفي ثراء من «الوجود» الزاخر الممتد اللاحب ، الذي لا يقف عند عمره الفردي المحدود.
ويجد الإنسان في قلبه هذا النور ، فتتكشف له حقائق هذا الدين ، ومنهجه في العمل والحركة ، تكشفا عجيبا .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يجد هذا النور .. مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذا الدين وحقائقه. ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته. إن هذا الدين لا يعود مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات .. إنما يبدو «تصميما» واحدا متداخلا متراكبا متناسقا ..
متعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وفي صداقة وثيقة ، وفي حب ودود!
ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فتتكشف له حقائق الوجود ، وحقائق الحياة ، وحقائق الناس ، وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في عالم الناس .. تتكشف له في مشهد كذلك رائع باهر .. مشهد السّنّة الدقيقة التي تتوالى مقدماتها ونتائجها في نظام محكم ولكنه فطري ميسر .. ومشهد المشيئة القادرة من وراء السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طليقة .. ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق النواميس وهي في هذا النطاق أيضا.
ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وفي كل أمر وفي كل حدث .. يجد الوضوح في نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته. ويجد الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة اللّه النافذة ، أو من أعمال الناس ونواياهم وخططهم المستترة والظاهرة! ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وفي الواقع من حوله ، كأنه يقرأ من كتاب! ويجد الإنسان في قلبه هذا النور ، فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه! ويجد الراحة في باله وحاله ومآله! ويجد الرفق واليسر في إيراد الأمور وإصدارها ، وفي استقبال الأحداث واستدبارها! ويجد الطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة وفي كل حين! وهكذا يصور التعبير القرآني الفريد تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحية :
«أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ ، وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ، كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها؟».
كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين. قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحييها ، ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع والاستشراف .. كانت قلوبهم مواتا. وكانت أرواحهم ظلاما .. ثم إذا قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتهتز ، وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضي ء ، ويفيض منها النور فتمشي به في الناس تهدي الضال ، وتلتقط الشارد ، وتطمئن الخائف ، وتحرر المستعبد ، وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في الأرض ميلاد الإنسان الجديد. الإنسان المتحرر المستنير الذي خرج بعبوديته للّه وحده من عبودية العبيد! أفمن نفخ اللّه في روحه الحياة ، وأفاض على قلبه النور .. كمن حاله أنه في الظلمات ، لا مخرج له منها؟
إنهما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان! فما الذي يمسك بمن في الظلمات والنور حوله يفيض؟
«كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» ..
هذا هو السر .. إن هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت! والذي ينشئ هذا التزيين ابتداء هو مشيئة اللّه التي أودعت فطرة هذا الكائن الإنساني الاستعداد المزدوج لحب النور وحب الظلمة ، تبتليه بالاختيار للظلمة أو النور. فإذا اختار الظلمة زينت له ولج في الضلال حتى لا يخرج من الظلمة ولا يعود ، ثم إن هناك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ، ويزينون للكافرين ما يعملون .. والقلب الذي ينقطع عن الحياة والإيمان والنور ، يسمع في الظلمة للوسوسة ولا يرى ولا يحس ولا يميز الهدى من الضلال في ذلك الظلام العميق! .. وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ..
وبنفس الطريقة ، ولنفس الأسباب ، وعلى هذه القاعدة جعل اللّه في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها .. ليتم الابتلاء وينفذ القدر وتتحقق الحكمة ويمضي كل فيما هو ميسر له ، وينال كل جزاءه في نهاية المطاف : «وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها ، وَما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ».
إنها سنة جارية أن ينتدب في كل قرية - وهي المدينة الكبيرة والعاصمة - نفر من أكابر المجرمين فيها ، يقفون موقف العداء من دين اللّه. ذلك أن دين اللّه يبدأ من نقطة تجريد هؤلاء الأكابر من السلطان الذي يستطيلون به على الناس ، ومن الربوبية التي يتعبدون بها الناس ، ومن الحاكمية التي يستذلون بها الرقاب ، ويرد هذا كله إلى اللّه وحده .. بِرَبِّ النَّاسِ .. مَلِكِ النَّاسِ .. إِلهِ النَّاسِ ..
إنها سنة من أصل الفطرة .. أن يرسل اللّه رسله بالحق .. بهذا الحق الذي يجرد مدعي الألوهية من الألوهية والربوبية والحاكمية. فيجهر هؤلاء بالعداوة لدين اللّه ورسل اللّه. ثم يمكرون مكرهم في القرى ، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويتعاونون مع شياطين الجن في المعركة مع الحق والهدى ، وفي نشر الباطل والضلال ، واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر والخافي ..
إنها سنة جارية. ومعركة محتومة. لأنها تقوم على أساس التناقض الكامل بين القاعدة الأولى في دين اللّه - وهي رد الحاكمية كلها للّه - وبين أطماع المجرمين في القرى. بل بين وجودهم أصلا ..
معركة لا مفر للنبي أن يخوضها ، فهو لا يملك أن يتقيها ، ولا مفر للمؤمنين بالنبي أن يخوضوها وأن يمضوا إلى النهاية فيها .. واللّه سبحانه يطمئن أولياءه .. إن كيد أكابر المجرمين - مهما ضخم واستطال - لا يحيق إلا بهم في نهاية المطاف. إن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم فاللّه وليهم فيها ، وهو حسبهم ، وهو يرد على الكائدين كيدهم : «وَما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ».
فليطمئن المؤمنون! ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر في نفوس أعداء رسل اللّه ودينه .. الكبر الذي يمنعهم من الإسلام خيفة أن يرجعوا عبادا للّه كسائر العباد ، فهم يطلبون امتيازا ذاتيا يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع. ويكبر عليهم أن يؤمنوا للنبي فيسلموا له ، وقد تعودوا أن يكونوا في مقام الربوبية للأتباع ، وأن يشرعوا لهم فيقبلوا منهم التشريع ، وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع .. من أجل ذلك يقولون قولتهم المنكرة الغبية كذلك : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل اللّه :
«وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا : لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ».
وقد قال الوليد بن المغيرة : لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك ، لأني أكبر منك سنا ، وأكثر منك مالا! وقال أبو جهل : واللّه لا نرضى به ولا نتبعه أبدا ، إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه! وواضح أن الكبر النفسي ، وما اعتاده الأكابر من الخصوصية بين الأتباع ، ومظهر هذه الخصوصية الأول هو الأمر منهم والطاعة والاتباع من الأتباع! .. واضح أن هذا من أسباب تزيين الكفر في نفوسهم ، ووقوفهم من الرسل والدين موقف العداء.
ويرد اللّه على قولتهم المنكرة الغبية .. أولا بتقرير أن أمر اختيار الرسل للرسالة موكول إلى علمه المحيط بمن يليق بهذا الأمر الكوني الخطير .. ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير وسوء المصير :
«اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ» ..
إن الرسالة أمر هائل خطير. أمر كوني تتصل فيه الإرادة الأزلية الأبدية بحركة عبد من العبيد. ويتصل فيه الملأ الأعلى بعالم الإنسان المحدود. وتتصل فيه السماء بالأرض ، والدنيا بالآخرة ، ويتمثل فيه الحق الكلي ، في قلب بشر ، وفي واقع ناس ، وفي حركة تاريخ. وتتجرد فيها كينونة بشرية من حظ ذاتها لتخلص للّه كاملة ، لا خلوص النية والعمل وحده ، ولكن كذلك خلوص المحل الذي يملؤه هذا الأمر الخطير. فذات الرسول - r - تصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة. وهي لا تتصل هذه الصلة إلا أن تكون من ناحية عنصرها الذاتي صالحة للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود ..
واللّه وحده - سبحانه - هو الذي يعلم أين يضع رسالته ، ويختار لها الذات التي تنتدب من بين ألوف الملايين ، ويقال لصاحبها : أنت منتدب لهذا الأمر الهائل الخطير.
والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة أو يطلبون أن يؤتوا مثل ما أوتي الرسول .. هم أولا من طبيعة لا تصلح أساسا لهذا الأمر. فهم يتخذون من ذواتهم محورا للوجود الكوني! والرسل من طبيعة أخرى ، طبيعة من يتلقى الرسالة مستسلما ، ويهب لها نفسه ، وينسى فيها ذاته ، ويؤتاها من غير تطلع ولا ارتقاب : «وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ ، إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ» .. ثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل ، ولا يعلمون أن اللّه وحده هو الذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح ..
لذلك يجبههم الرد الحاسم : «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ» ..
وقد جعلها سبحانه حيث علم ، واختار لها أكرم خلقه وأخلصهم ، وجعل الرسل هم ذلك الرهط الكريم ، حتى انتهت إلى محمد خير خلق اللّه وخاتم النبيين.
ثم التهديد بالصغار والهوان على اللّه ، وبالعذاب الشديد المهين :
«سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ» ..
والصغار عند اللّه يقابل الاستعلاء عند الأتباع ، والاستكبار عن الحق ، والتطاول إلى مقام رسل اللّه! ..
والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد ، والعداء للرسل ، والأذى للمؤمنين.
===============

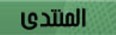

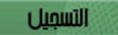
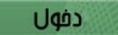

 المزاج
المزاج










